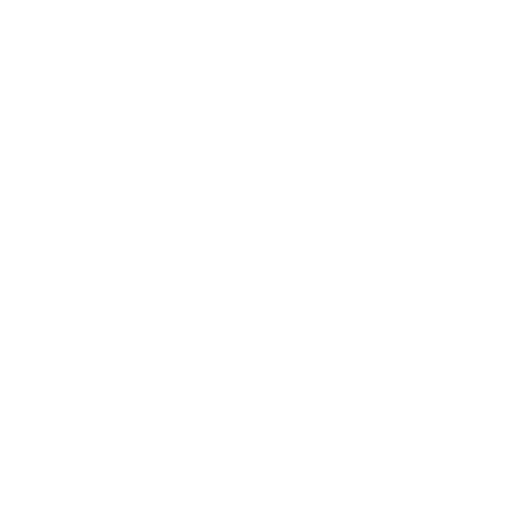الفساد أصل الكارثة في درنة: صرخة الشاعر نبوءة محققة!
30-09-2023 03:22 PM GMT+03:00
ليست المرّة الأولى التي تنهار فيها السدود، لا عالميًّا ولا تاريخيًّا، لكن النقطة الجوهرية هي في طرق التعامل مع المشكلة قبل أن تصبح خطرًا ثم كارثة جسيمة بحقّ الشعوب والإنسانية. بل القضية الأهم كيفية البناء على أسس سليمة وبأيدي ماهرة وضمائر نزيهة وعقول علمية وخيال ابتكاري، مما نفتقده في دولٍ كثيرة في منطقتنا العربية التي حكمتها طغمة من المستبدّين أسّسوا لظلام وظلم، لم يكن الشعب يومًا في حساباتهم، لا المصرفية ولا الإجرائية ولا في تحسين البلاد، إلّا بما يستجرّ المال إلى حساباتهم البنكية، ويجر الويلات على البلاد والعباد، ولنا في سورية أمثلة كثيرة.
سدّا درنة ينهاران، فيُحدثان الكارثة البشرية الممتدة، ليس فقط بحصد آلاف الضحايا، وتشريد آلاف غيرها، وتعطيل حياة آلاف أخرى، وتبديد أسر وزرع الحزن في قلوب آلافٍ ممن فقدوا أعزّاء، بل هي كارثة ممتدّة لما ستخلف من مخاطر بيئية، فتحلّ الأمراض المستدامة والتلوث المستدام مكان التنمية المستدامة التي كان من المفترض أن تُبنى السدود لأجلها، فبُنيت تحت رعاية الفساد والمعرفة الناقصة والخبرة المحدودة والمسؤولية المغيّبة والضمائر الغائبة، واسترخاص أرواح البشر، في وقت صارت فيه الدول القوية تطوّر حتى قدراتها العسكرية والحربية في مجالات الذكاء الاصطناعي للتقليل من هدر الأرواح البشرية "لمواطنيها" في الحروب، الدول المتقدّمة علميًا وتقنيًا وديمقراطية، أقلّه بالنسبة إلى شعوبها، تحترم الإنسان وتحرص على حياته، فإذا أخطأت الحكومات استقالت، أو أقالها الشعب وأحيل المخطئ إلى المحاكمة، أمّا في بلداننا المتهالكة هذه فويل لشعوبها من الاستبداد المديد الذي يورّث كما تورّث أي ملكية.
دول فاشلة، صحيح. مجتمعات متهالكة، صحيح. ولكن هل الحرب وحدها المسؤولة، على الرغم من مسؤوليّتها العظمى؟ ما الذي أوصل البلاد ومن أوصلها إلى الحرب وإلى حافّة الانهيار؟ في ليبيا حكومتان متحاربتان ومتنافستان منذ أكثر من عقد من الحرب والفوضى، ووصلت البلاد إلى ما هي عليه، وكانت كارثة درنة الصادمة، بحصيلتها السريعة التي لم تستغرق ساعات، على الرغم من إنذارات سابقة من مهتمّين وعارفين، ومن دقّ ناقوس الخطر، لكن الكارثة الكبرى هي تلك الممتدة من دون أفق لنهايتها، إنه النزاع على السلطة والحيازة والتحكّم في المصير، بين أطراف مسنودة من الخارج، تدير الحروب بأبناء ليبيا وتستنجد بالدعم وبالمرتزقة من مناطق أخرى، كما الحال في سورية، في اليمن، في العراق، في مناطق كثيرة من وطننا العربي، في أفريقيا، في أرجاء هذه المعمورة التي نسميها "كوكبنا"، وهي، في الواقع، ليست لنا، بل لأنظمة المال والاحتكارات العالمية التي تدير هذه الحروب، وترعى (وتدعم) أنظمة طغيان تستبيح شعوبها.
أمست السدود كوارث ماثلة في البال، وهي كثيرة، فالسدود حاجةٌ ضروريةٌ من أجل حياة الناس، خصوصا في ظل التغيرات المناخية الكارثية وتهديد العطش والجفاف الذي يتفاقم عامًا بعد عام، لكنها صارت كالوحش الجاثم فوق حياة المساكين الذين تتركهم حكوماتهم، بعد أن تُصادر أراضيهم لأجل بناء السدود خدمة "للصالح العام"، لأقدارهم، فيبحثون عن أبسط حقوقهم في الحياة "مسكن ولقمة عيش"، ويبدأون ببناء أعشاشهم الهشّة، بيوتهم البسيطة بأقل التكاليف على تخوم مساكنهم وأراضيهم التي صودرت، يزرعون من دون اكتراث بأي من عوامل السلامة والأمن الحياتي، في غياب كامل للحكومات وأدوارها. وفي سورية شاهد ما زال ماثلًا في البال والذاكرة، "سدّ زيزون"، الذي انهار في الرابع من يونيو/ حزيران عام 2002، من دون أعاصير، انهار لأن جسم السدّ تشقّق في الصباح الباكر، لينهار في الثالثة بعد الظهر، ويغمر أكثر من ثمانية آلاف هكتار أسبوعا، بحسب التقارير الحكومية، فقضى عشرات من الضحايا، ونفقت الآلاف من رؤوس الماشية وخلايا النحل، وانهارت البيوت في قرى عديدة، وكذلك المدارس والبنى التحتية من طرق وشبكة كهرباء واتصالات ومياه وغيرها. قدّمت الحكومة حينها أرقامًا وإحصائياتٍ عن الكارثة، وتفسيراتٍ عن أسباب حدوثها، لكن غالبية الناس لم يصدّقوا، من دون أن يكون لديهم ما يدحض الادّعاءات، فالمعرفة كلها في قبضة السلطة، وهي المحتكرة الحصرية لإنتاج المعرفة في الدولة. لذلك عانى الناس طويلًا من فقر الخيال والعجز في البحث عن الحقيقة، عدا عن أن الثقة شبه معدومة بما يصدُر عن الحكومة، على رأي الراحل ممدوح عدوان بأنها حكومة "تكذب حتى في النشرة الجوية". وأسدل الستار عن كارثة ترقى إلى مرتبة الجريمة بحق الشعب.
تتوزّع الثروة المائية في سورية، المقسّمة حاليًّا في الواقع بين سلطات عديدة، على ثمانية أحواض مائية رئيسية: الفرات، دجلة والخابور، العاصي، الساحل، البادية، اليرموك، بردى، حلب، منها ما تغذّيه مياه الأمطار والثلوج، ومنها ما تتشكّل تجمّعاته المائية من الأنهار الداخلية أو الخارجية. يعدّ سد الفرات من أكبر السدود في سورية، ولا ننسى حالة الهلع والذعر التي سيطرت على الناس في العام 2017، بسبب العمليات العسكرية بين مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من جهة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) والتحالف، وكذلك كل الفصائل والقوات المتحاربة هناك، من انهيار السد وأي كارثة ستلحق بالمنطقة.
لقراءة المقال كاملًا اضغط على المصدر
المصدر : العربي الجديد