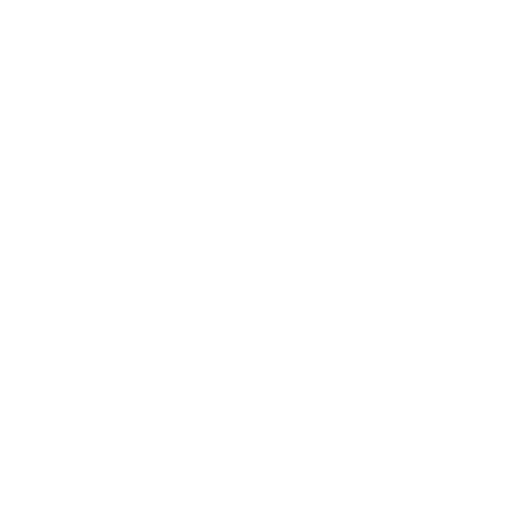لبنان بلدٌ للحريات... حتى لساحات الموت
11-01-2024 01:28 PM GMT+02:00
كتب الدكتور داود الصايغ
كانت بيروت رحبة حتى لساحات الموت. هكذا فهم البعض حرّياتها. كلّ شيء فيها مباحٌ ومُستباح، إلى حدّ فرض إدخالها في "وحدة الساحات" التي قضى مهندسها، ويا لسخرية القدر في غير الساحة التي تمناها.
العواصم العربية الأخرى أقفلت أبوابها وفتحت زنزاناتها. وزنّرت كياناتها بالحديد والنار، ولا تزال. ولكن الدخول في مجال المسؤوليات التي رافقت المآسي الفلسطينية في لبنان منذ "النكبة" عام ١٩٤٨ وحتى اليوم فات أوانه. على أن سؤالًا يتبادر إلى الذهن: مهندس وحدة الساحات قضى في ساحة لبنان ودُفن فيها. لماذا؟ من أذن لهذا المناضل الفلسطيني أن يُدخل لبنان في ساحات نضاله؟ هل لأن أحدًا لم يقف في طريقه، وأن حلفاء له لاقوه في منتصف الطريق إياها وفق حساباتٍ لم يكن لبنان ومصلحته فيها. أم لأنه لم تكن هنالك سلطة قادرة ورادعة وواعية للتطورات منذ حرب ١٩٦٧ وحتى اليوم تحمي لبنان من المتلاعبين بأمنه. وهنا عمق المأساة وجوهر المشكلة.
فما سُميَ بوحدة الساحات تمّ الإعداد له منذ سنوات. فصالح العاروري لَحِقَ بقافلةٍ طويلة تمّ ترداد أصحاب أسمائها من كمال عدوان وكمال ناصر وأبو يوسف النجّار قياديي حركة فتح الذين قضوا في شهر نيسان ١٩٧٣ في شارع فردان ببيروت، إثر عمليةٍ نفّذها عملاءٌ إسرائيليون قدموا من البحر. فكانت أزمةٌ كبيرة، في تقصير الداخل المفضوح من جهة الذي أدّى إلى استقالة حكومة الرئيس صائب سلام وفي عودة التوتّر مع منظّمة التحرير من جهةٍ ثانية التي قادت إلى توقيع اتّفاقٍ ثانٍ عُرف باتّفاقية "ملكرت" في أيار ١٩٧٣. وبعد ذلك بسنتَين تفجرّت الحروب اللبنانية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم.
وكان الكاتب الفلسطيني المعروف غسّان كنفاني قد اغتيل بسيارةٍ مفخّخة قبل سنة من ذلك في محلّة مار تقلا. يا للغرابة! أي عاصمةٍ عربية غير بيروت تحمل شوارعها مثل هذه الأسماء التي تُشير إلى الخصوصية اللبنانية، يقضي فيها قادة المنظّمات الفلسطينية؟ إنها من ريادة لبنان ومن فرادته، ولكن من أبوابه غير المحروسة، التي تسلّل عبرها صاحب كلّ قضية، فإذا بالفصائل الفلسطينية كلّها ممثّلة في لبنان، في لبنان حاليًا، داخل المخيمات وخارجها، لا لشيء سوى لأن حرّيات لبنان المعروفة بالنسبة إلى العرب والعالم، تحوّلت في بعض الزمان إلى استغلالٍ معلن.
نقول ذلك لأن الفلسطينيين يعرفون أكثر من غيرهم أن إسرائيل تكنّ للبنان عداءً خاصًا. إنها تكره حرّياته وتميّزه واختلاطه الطائفي. كونه نقيضها، مذ أدرك ذلك المفكّرون اللبنانيون المؤسِّـسون في البدء، على نحو ما تكرّر قوله في هذه الصفحات. ولعلها كانت تفضّل ولا تزال التعامل مع أنظمةٍ عربية متجانسة بشريًا ولو متشدّدة حيث لا كلام إلّا للحاكم الفرد. وليس مثل لبنان المختلف والحائر في رأيها والمشرّع الأبواب. وإلّا ماذا يبرّر تدميره سابقًا والتهديد بإعادته إلى العصر الحجري على نحو ما يهدّد قادتها حاليًا. وهذا ما يُدركه القادة الفلسطينيون جيدًا.
ولم يكن هنالك حتى الآن، حتى هذه الساعات الحرجة بالذات، من يقول لهؤلاء ولحلفائهم في لبنان: انتبهوا أيها الإخوة إذا كنتم إخوة. مصلحة لبنان تعلو على مصالحكم وإن كانت محقّة فأنتم في ضيافته. فهو كان ولا يزال رئتكم الوحيدة للتنفّس في الشرق، فانهلوا من هذا الهواء المنعش القادم من أعماق التاريخ ولا تلقوا أحجاركم في الينابيع الدافقة بالخير والسنى. وقارنوا بين وجودكم فيه ووجود زملائكم في سجون أخوتكم الآخرين تمامًا مثل سجون العدو.
الآن فات وقت محاسبة الفلسطينيين الذين دفع لبنان في سبيل قضيتهم أثمان حروب السنوات الأولى ما بين ١٩٧٥ و١٩٨٢، تاريخ فرض مغادرتهم لبنان، والذين كانوا في وسط هذه الحروب. فات أوان محاسبتهم، وسؤالهم عن عودة نشاطهم، لأن هنالك فريقًا لبنانيًا بات يتحمّل المسؤولية عنهم وإلى جانبهم، ولو لمصالح أخرى. وهي الحسابات الإيرانية، وقد دفع شبابه بالأمس القريب واليوم في سوريا وفي لبنان أثمان مئات الدماء الشابة لحساباتٍ ليس أكيدًا أنها تُبذل لمصلحة لبنان. مع اعتراف الجميع بأفضال التحرير عام ٢٠٠٠.
ولكن أين نحن الآن من حوالي ربع القرن الماضي، ولبنان واقفٌ، مسمّرٌ في دولته ومؤسّساته وأزماته وأهوال انفجار مرفأ عاصمته، وملايين النازحين السوريين، على ما تُقرّره تلك المصلحة غير العربية بأبسط الأوصاف وهي الحالة الإيرانية.
أين نحن الآن والحكومة تُصرّف الأعمال منذ أكثر من سنة ورئيسها أعلن بكلّ وضوح أن لا قدرة للدولة أن تقرّر في شأن الحرب والسلم. وأن الأصدقاء الفاعلين في العالم مثل أميركا وفرنسا يكتفون ببذل الجهود الدبلوماسية من أجل عدم توسّع الحرب نحو لبنان.
فلسطين كانت في الحسبان منذ البدء لعوامل معروفة. وكانت بيروت منبر قضية العرب الأولى ومنطلق كلمتها. ولكن إيران لم تكن أبدًا في الحسبان، فكيف صارت هي الحسبان، متقدّمةً على القضية الفلسطينية. فباتت تقام في لبنان احتفالات وأنصبة لقادة إيرانيين مثل قاسم سليماني الذي اغتالته القوّات الأميركية في بغداد. وحدة الساحات هذه؟ قائدٌ إيراني مع قائدٍ فلسطيني يقام لهما في الوقت ذاته وفي اليوم ذاته مآتم واحتفالات في لبنان. لماذا لبنان.
لم تكن إيران في الحسبان. إنها كانت في عالمٍ آخر. في الحضور الفاعل في المنطقة والعالم مع خامس أكبر جيشٍ، مع الشاه محمد رضى بهلوي الذي كان يحطّ في مطار بيروت في طريقه إلى طهران، وفي احتفالات برسيبوليس المبهرة في خريف ١٩٧١ بمناسبة ما سُمّيَ بمرور ألفان وخمسمئة عام على تأسيس الإمبراطورية الفارسية، والتي كانت بمثابة الوداع المبكر لهذه الإمبراطورية حليفة الغرب الذي خذل الشاه عندما رفضت أميركا جيمي كارتر استقباله بعد سقوطه، وهو حليفها الأول، فبَقيَ زمنًا مريضًا تائهًا بين البلدان إلى أن استقبله الرئيس المصري أنور السادات وأقام له لدى وفاته جنازةً إمبراطوريةً في ٢٧ تموز ١٩٨٠.
حينذاك لعبت الأقدار لعبتها الحاسمة. فانتقلت إيران من زمنٍ إلى زمن. وانتقلت معها منطقة الشرق الأوسط من حالٍ إلى حال. ولعل السؤال يبدو ساذجًا بعد حوالي خمسةٍ وأربعين عامًا حين نقول إذا كانت تلك هي التطورات فكيف حضرت إيران إلى لبنان وأصبحت مقررة في شؤونه، في مختلف شؤونه الداخلية والإقليمية، إلى حدّ تعريضه لمختلف الأخطار خدمةً لمصالحها، وسط انكفاءٍ عربي وتخلٍّ عن بلدٍ عربي مؤسّـس للجامعة العربية وصاحب أغنى الأفضال على العروبة. كيف حصل ذلك. فما الذي جرى حتى دخل لبنان بصورة تدريجية خلال العقد الأخير من القرن الماضي في "الحقبة الإيرانية" على ما يصفها بعض أصحاب الرأي. الحقبة الإيرانية؟ كيف ولماذا؟
إيران حضرت. ولكن لماذا هذا الهدوء العربي كما ذكرت جريدة لوموند في عددها الصادر في ٢٧ الشهر الفائت. هدوء أم ارتباك أم حسابات مصالح. فالقضية الفلسطينية ما عادت الهمّ العربي الأول. ولذا من حق اللبنانيين أن يسألوا: لماذا نحن، البلد العربي المميز، المنفتح، النموذج، القدوة، الذي أحبّه العرب عليه أن يدفع الأثمان. خدمةً لمن، إذا كان ذلك لفلسطين فقد دفعنا أكثر بكثير مما هو متوجب. أما إذا كان لإيران فهنا لا بد من التوقف قليلًا، لأننا ندخل في عمق الأزمة اللبنانية الحالية من مختلف جوانبها:
في آخر صيف ١٩٧٠ وقعت ثلاثة أحداثٍ كُبرى حوّلت مصير لبنان وهي وفاة الرئيس جمال عبد الناصر في ٢٨ أيلول، ووفاة الجنرال شارل ديغول في ٩ تشرين الثاني وهما كانا الصديقين الحاميين للبنان، بما يمثلان شخصيًا وبما تُمثله بلادهما. ولكن في الفترة نفسها وصل الرئيس حافظ الأسد إلى رأس السلطة في دمشق. فقد كان للأشخاص الثلاثة هؤلاء، في الغياب وفي الحضور تأثير بالغ الأهمية على كلّ ما جرى في لبنان بعد ذلك.
وكان لوصول حافظ الأسد من تأثيرٍ مباشر فيما بعد إن في حرب ١٩٧٣ وإن في الدخول العسكري السوري إلى لبنان بناءً على التسهيل الأميركي المعروف عام ١٩٧٦ كما سبق وذُكر، وإن بخاصةٍ من إقامة ذلك المحور، الذي أُدخل لبنان فيه مع إيران حليفة ذلك النظام خلافًا لكل مراحل التاريخ اللبناني الحديث في الابتعاد عن الأحلاف.
وهكذا في مطلع سنة ٢٠٢٤، بعد أربعة وخمسين عامًا على تلك الأحداث المصيرية في أيلول ١٩٧٠، وجدَ اللبنانيون أنفسهم أمام واقعٍ ترفضه غالبيتهم الساحقة: الغرب في انكفاء إلا فيما يعود إلى الحؤول دون توسع المواجهة مع إسرائيل، العرب في حالة انكفاءٍ تام عن لبنان وهم يتحملون بالتأكيد مسؤولية التضامن مع بلدٍ عربي تركوه لصراعات الآخرين.
الأولوية المطلقة تكمن في حلٍ وحيد وهو إعادة تكوين السلطة، بالشرعية الدستورية التي قام عليها لبنان أصلًا وهي الخطوة الوحيدة على طريق حماية لبنان. دولةٌ ضمن دولة كانت حالةً لم ينتج عنها سوى الأضرار، تمامًا مثل زمن الوصاية. السلاح خارج الدولة لا يُنتج دولة. شعبٌ وجيشٌ ومقاومة كان شعارًا قاد إلى الخراب. إيران دولةٌ غريبة مهما فعلت. والذين قضوا في سبيل تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي عام ٢٠٠٠ هم شهداء لبنانيون.
للصداقة مع لبنان شروط. فالصداقة شيء ومدّ النفوذ العقائدي شيء آخر. فلبنان ليس في عقيدة أحد ولا في مشروع أحد ولا في أطماعه. وهذا ما أدركه السوريون جيدًا. فلماذا لا يتّعظ الإيرانيون. وقبل الإيرانيين متى تُفتح بصائر بعض اللبنانيين على الواقع، أقلّه واقع الربح والخسارة. فما من أحدٍ يربح في لبنان سوى لبنان، وجميع الباقين خاسرون. هكذا علّم التاريخ منذ البدء وكلّ شيءٍ قيل في البدء.