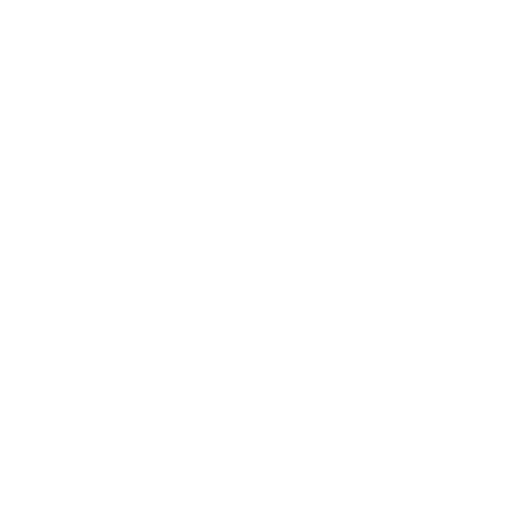طهران: 45 عاماً من التحدي
08-03-2024 02:50 PM GMT+02:00
استنكارات دولية بالجملة تتهم طهران بالضلوع بالأحداث في المنطقة: صواريخ حزب الله على شمال إسرائيل، ومضايقات الحوثيين للسفن في البحر الأحمر، والدعم اللوجستي لحماس في غزة، والهجمات على القواعد الأميركية. وهذا ليس بجديد فجمهورية إيران الإسلامية، استثمرت على مدى 45 عامًا، في توسيع نفوذها في المنطقة. أما نقطة البداية فالثورة الدينية غير المسبوقة، التي قادها آية الله الخميني عام 1979. وفرض الخميني، متوجاً بهالة الشيعة الاثني عشرية، سيادة المرشد الديني وحدد “توسيع السيادة الإلهية في العالم والدفاع عن المظلومين ووحدة العالم الإسلامي” كأهداف أساسية للدولة الدينية.
هذا المقال يسلط الضوء على أصول المسيانية الفارسية التي غيرت التوازنات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وصدرت النشاط الإسلامي إلى الغرب في جوانبه الأكثر تطرفًا.
“لم تهدف الثورة الإيرانية للإطاحة بالنظام الملكي، بل لإرساء أسس جمهورية الوحي الإلهي”.
بعد وقت قصير من عودته المظفرة إلى طهران في الأول من شباط 1979، لم يخف آية الله الخميني في خطابه، نواياه وعزمه على تحويل إيران إلى جمهورية إسلامية.. المشروع الذي عكف على تطويره خلال الأعوام الخمسة عشر التي قضاها في المنفى. وهذا ما تحقق بعد عودته بشهرين، بمجرد أن سيطر أتباعه على البلاد وأسكتوا جميع معارضي الثيوقراطية.
لا شك بأنّ الوجه القاتم لرجل الدين الذي تخطى أعوامه الـ77 وصوته المخنوق لا يسمحان له تحديداً بإشعال المنابر، لكن نظرته القاسية والباردة تكشف عن نار داخلية ورغبة لا هوادة فيها في الانتقام. ونظراً لأنه عارض الشاه منذ الستينيات، فقد تمتع بمكانة هائلة بين رجال الدين الأدنى والطبقات العاملة المتدينة. ووصل إلى السلطة مدعومًا بمجموعة من المثقفين الدينيين الذين أعدوا العدة لوصوله والذين أخذوا على عاتقهم مهمة مساعدته في تنفيذ إستراتيجية الغزو.
وبالفعل، ارتفعت هتافات “الله أكبر” على لسان آلاف الإيرانيين قبل شهرين من عودته! وسرت شائعات من بيت إلى بيت مع مزاعم حول رؤية وجه آية الله على القمر! ومن خلال البناء الذكي على هذه الحكاية، احتفل رجال الدين بالحدث في المساجد، وأعلنوا بصيغة جريئة أن “المهدي سيعود عندما تشرق الشمس من الغرب”. وللمصادفة كان الخميني، الذي انعكس وجهه على القمر مثل الشمس، آنذاك في الغرب، في فرنسا، في قرية “نوفل لو شاتو”…
ومما لا شك فيه أنّ لهذا التبجيل جذور في اللاوعي الجماعي للفرس. فشخصية الخميني تعكس أسطورة الإمام المخفي الثاني عشر. ووُلد المذهب الشيعي الاثني عشري، أو الإمامي، الذي يعد الإيرانيون من أكثر أتباعه عددًا، من الصراع بين خلفاء النبي محمد. ويعترف الشيعة بصهر النبي محمد، الإمام علي وأحفاده الأحد عشر باعتبارهم المرشدين الروحيين الحقيقيين الوحيدين للمسلمين. أما الإمام الثاني عشر محمد المهدي الذي اختفى في ظروف غامضة عن أعين الأحياء وهو في الخامسة من عمره فيعتبر سيد الزمان والمنقذ الذي سيظهر في نهاية غيبته الكبرى لينزل وحي القرآن الحقيقي ويرسي الحكم المثالي والعدالة الشاملة.
وحتى إن لم يثبت أنّ الخميني هو المهدي، فقد عرض كمن ينوب عنه بقوة. وهذا ما ترجمته عند عودته، ربط اسمه بلقب الإمام وبمجموعة من الألقاب: “المرشد الأعلى للمسلمين”، “وصي الإمام الغائب”، “المدافع المجيد عن الإيمان”، “المنتقم”، “مدمر الأصنام”، “قاهر الشيطان”، “الرجاء الوحيد للمظلومين”.
عقيدة الشهادة
مجد الخميني لم يتوقف عند هذا الحد فهو يكمن في نظر أتباعه، أيضًا في سنين منفاه الطويل، والتي جعلت منه “شخصًا مضطهدًا” و”شهيدًا”. وبهذا تتماهى صورته مع صورة سيد الشهداء الحسين بن علي، الإمام الثالث الذي قُتل وقطع رأسه على يد خصومه في معركة كربلاء عام 680، حدث في قلب الانقسام بين الشيعة والسنة. وجذر سياق النهاية المأساوية لأحفاد علي عقيدة الشهادة بعمق في الفكر الديني الشيعي. وهذا ما يظهر جلياً في خطاب مرتضى مطهري، أحد منظري الجمهورية الإسلامية والمستشار المقرب من الخميني، والذي يعتبر أنّ الإسلام ليس الدين الذي يدعو لإدارة الخد الأيسر كما في المسيحية، بل هو دين الثورة والدم والاستشهاد.
ولعل الرمز الأكثر بلاغة لقداسة الشهادة موجود في المقبرة الجنوبية الكبرى في طهران حيث تنتصب نافورة بارتفاع 5 أمتار، يتدفق منها سائل أحمر اللون، ويتسمر الحجاج أمامها للتأمل. يعبر هذا النصب حسب الخميني عن “جوهر رسالة الإسلام”.
مبدأ الاستشهاد بلغ ذروته خلال الحرب مع العراق، من عام 1980 إلى عام 1988. حينها، حشد حزب الله آلاف المراهقين على الجبهة، مع التلويح بشعار ساخر يدعو الناس للتضحية بأحد أبنائكم للإمام! دعوة لقيت صدى لدى أكثر من مليون عائلة متعصبة. وأقسم الأطفال الذين حصلوا على كلاشينكوف ولبسوا مفتاحاً بلاستيكياً للجنة حول أعناقهم بالقيام بواجبهم المقدس بصفتهم أبناء الإمام وجنود الإسلام في الجهاد المقدس الذي يهدف لإعادة نور العدل الإلهي إلى الدنيا.
وأرسل عدد معين من هؤلاء الأطفال، مرتدين العصابات الحمراء التي ترمز للشهادة، لتفجير أنفسهم في حقول الألغام لتسهيل تقدم القوات.
وبمجرد أن أسس لسلطته، ظهر “المدافع المجيد عن الإيمان” جاثمًا على شرفة، محاطًا بتأثيرات ذكية للضوء بشكل يمنحه مظهرًا مقدسًا. توافد الناس من جميع أنحاء العالم الإسلامي لرؤية الرجل المقدس في حرمه في نيافاران والاستماع إلى خطابه المعجزة. رآه المؤمنون الذين افترشوا الأرض، بالفعل ممثلاً لله، والحامل المعصوم للرسالة إلى العالم الإسلامي ككل. ألم يعلن أن الأول من نيسان 1979، تاريخ التأسيس الرسمي للجمهورية الإسلامية، هو فجر عهد الله وانهيار الباطل والسيطرة الشيطانية لصالح حكم المحرومين؟
“الملك الفيلسوف”
بالنسبة لأولئك المهتمين بدروس التاريخ (التي يبدو أن أحداً لا يتعلم منها!)، من الجيد استذكار ثلة من الناس، خارج إيران، كانوا يدركون في الأيام الأولى للثورة نية الخميني العالمية. فبعض المثقفين الأوروبيين المعروفين، وتحديداً جان بول سارتر وميشيل فوكو، الذين أصابهم قصر النظر، كما هو الحال غالبًا عندما يتعلق الأمر بالشرق المعقد، لا يخفون تعاطفهم مع الثورة الدينية التي يرون فيها “ثورة عفوية” وانفجار الطاقة الروحية و”عودة الإيمان بالحياة السياسية”. ولفترة طويلة، جعل هؤلاء من نظام الشاه الاستبدادي، الذي لا يخلو بالتأكيد من الأخطاء، هدفهم المفضل، وحقيقة أنّ آية الله تمكن من إسقاط دكتاتورية بهلوي الخاضعة للأميركيين كانت تكفي لإسعادهم. كانوا مفتونين بذلك الرجل العجوز الذي يلقي عظته بصوت هادئ وهو يحني رأسه تحت شجرة التفاح، ويلقى من الأوصاف ما شابه “قديس القرن العشرين”، و”غاندي الإسلام”! حتى أن وكالة المخابرات المركزية، أشارت في تقرير استشهدت به مجلة “تايم” في 10 فبراير 79، إلى أن “الخميني هو نوع من الملك الفيلسوف، وهو أخلاقي مثالي في التقليد الأفلاطوني، ينوي وضع حد للفساد، ثم ينسحب في عهده”.
الأفضل من ذلك بعد: عندما أراد كبار ضباط الجيش الإمبراطوري، الموالون للشاه، معارضة استيلاء الخميني على السلطة، جاء الجنرال الأميركي هويزر للتفاوض سراً على حيادهم، بحجة “أن النظام الإسلامي في إيران سيكون الحل الأمثل”. أفضل حصن ضد النفوذ السوفييتي في المنطقة.. خطأ كبير سيعيد الأميركيون ارتكابه في أفغانستان من خلال دعم أسامة بن لادن وطالبان ضد الغزو الروسي.
ومع ذلك، كما هو الحال في “كفاحي”، كل شيء محصى بكلمات. والخميني ليس غاندي. وكانت قراءة أقدم خطابات آية الله والاستماع إلى الأشرطة التي وزعها أنصاره بالمئات كافية لفهم مشروعه للدولة الدينية وفك خطاباته المليئة بالحرومات بكل أنواعها، ولا سيما ضد اليهود وعباد الصليب الذي أبرموا ميثاقًا سريًا لإذلال الإسلام واستئصاله من إيران.
قمع ومعارضة خجولة
لم تخل الأسابيع الأولى من عودة ممثل الله إلى طهران من الخطر خصوصاً وأنه لم يكن يمتلك بعد الأدوات اللازمة لضمان سلطته. فقام بتشكيل حكومة مؤقتة، لكن التوترات سادت بين فصائل متعددة. وتزايد خطر الفوضى. وساد الإنقسام بين كبار رجال الدين أنفسهم. وبعد اكتشاف نوايا الخميني الحقيقية، قاوم آيات الله العظمى المحترمون مثل الطالقاني وشريعتمداري، انطلاقاً من التقليد الشيعي القديم الذي يعارض تدخل رجال الدين في شؤون الدولة. بالنسبة لمؤيدي هذه العقيدة، إذا كان المذهب الشيعي دين احتجاج، فلا يمكن أن يكون هناك إسلام سياسي، بل ستنم الرغبة في الربط بين مصطلحي “الجمهورية” و”الإسلامي” عن تناقض عميق ولكن أصوات هؤلاء المعارضين ستخنق تدريجياً. تماماً مثل الأحزاب السياسية القائمة (من القوميين العلمانيين إلى اليسار) والتي لم تستسلم للثورة الخمينية إلا وكلها أمل بأن تتمكن من إقامة دولة ليبرالية تقدمية، حتى لو كانت ذات لون “إسلامي”، والتخلص من آية الله سريعاً.
بالطبع هذه ليست نية الخميني الذي لم ينطق مطلقًا بكلمة “حرية” والذي يعتبر الديمقراطية “نظامًا فاسدًا يروج له الغرب الكافر”. إن انتخاب أفراد من المجتمع المدني للتشريع خارج القانون الإلهي هو بدعة. وفي خطابه أمام الليبراليين الذين شكلوا الحكومة المؤقتة، دعا للتخلي عن الأيديولوجية والانضمام إلى الإسلام! وتوجه لرعيته بالدعوة لعدم الإستماع لأولئك الذين يتحدثون عن الديمقراطية. فهم ضد الإسلام. والحال سيان بالنسبة لكل من يتحدث عن القومية والديمقراطية وأشياء أخرى كثيرة…”. والأكثر تهديداً كان توجهه لمحاكمة كل هؤلاء الناس أمام المحاكم التي ينوي تشكيلها.
ومثلما وعد صدق! منذ مارس 1979، امتدت الرسالة الدينية إلى العمل السياسي الاستبدادي، وفي هذا التحول تكمن خصوصية النظام الديني الإيراني. شرع أنصار الإمام في تحييد كل من قاوم سيطرة رجال الدين على أعمال الدولة. ومع بزوغ فجر الدولة الشمولية، تدفق مقاتلو حزب الله إلى الشوارع، مستخدمين السكاكين والهراوات وقنابل المولوتوف ضد المتمردين. واغتيل المعارضون السياسيون، وأحرقت الصحف، وطوردت النساء اللاتي رفضن الحجاب. وتولت لجان إسلامية وضع القانون في الأحياء. ولتأسيس السلطة الجديدة، أنشأ الخميني ميليشيا الحرس الثوري (الباسداران) وأصبح الباسدارانيون، الذين يشكلون قوة شرطة وجيشاً موازيين، الجناح المسلح للاستبداد الديني في كافة مجالات المجتمع الإيراني، كما تحولوا في الخارج، لرأس حربة في السياسة الخارجية للملالي.
في صيف 1979، تولت المحاكم الإسلامية مسؤولية القضاء على جميع المشتبه بكونهم من أنصار “النظام الكافر”. وأصدر قضاة مستعجلون حكماً بإعدام 12 ألف شخص وسجن 100 ألف معارض، بينما اختار ثلاثة ملايين إيراني المنفى. وحينها أعلن المدعي العام لاجيفاردي بكل قسوة أن “البعض قد ينعتوننا بالإرهابيين الإسلاميين. لكننا لا نقوم إلا بطاعة أوامر الله. ولا نقتل إلا من أجله. ومن أجله فقط نرهب الكفار والمنافقين. نحن مجرد أدوات للإرادة الإلهية. والله نفسه هو الذي قرر تطهير هذا العالم قبل فوات الأوان!
ولاية الفقيه
وأخيراً وبعد جهود في الظلام وفي سرية تامة، اعتمد الدستور الجديد في كانون الأول 1979.. دستور يرتكز على مبدأ ولاية الفقيه، سلطة الفقه الديني. والآن وقد أصبح الخميني المرشد الأعلى مدى الحياة، بات بمقدوره وخلفائه المستقبليين، حصراً، التحقق من صحة أي قرار ذي طبيعة دينية أو سياسية أو اجتماعية أو عسكرية، مع ضمان عدم انحراف أي شيء عن مبادئ الإسلام. ويترجم ذلك في ديباجة دستور الجمهورية الإسلامية الذي ينص على “تطهير أمتنا نفسها من الغبار والعفن من التهجين الأيديولوجي مع الأجانب، من خلال إنجازها الثوري”، وهكذا عادت إلى المواقف والرؤى الدينية الإسلامية الأصيلة.
يمكننا بالتالي فهم معنى التحديات التي تطرحها طهران منذ أكثر من أربعة عقود.. ومن هذا المنظور، يبدو أن انتصار الإسلام في بلد واحد لا يكفي بنظر المرشد، فالقومية “تدمر أساس رسالة الأنبياء” وإيران لا تعدو كونها أكثر من “جزء محرر من أراضي الإسلام”.
المصدر : هنا لبنان